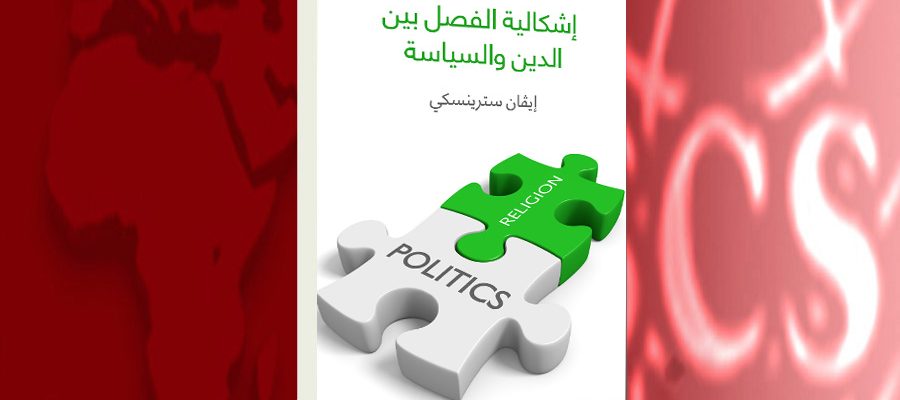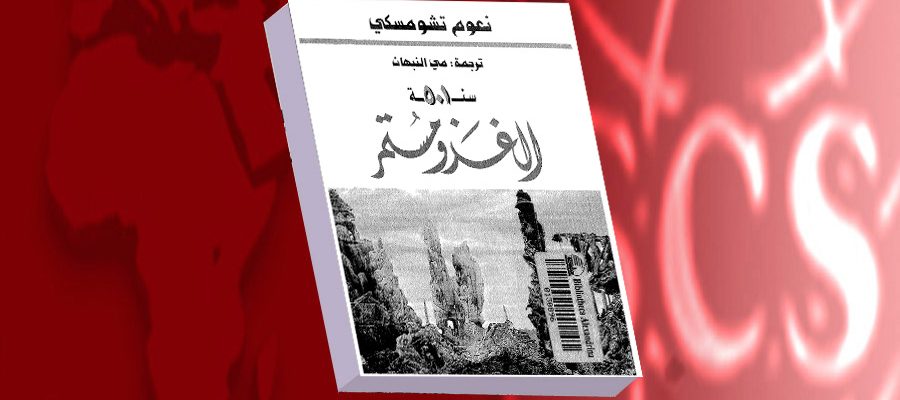جاءت إقالة رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، من منصبه هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه؛ لكي تفتح المجال واسعًا للحديث عن مشكلة، وتحدٍّ، شديدَا الأهمية، تواجه الدولة القومية الحديثة في العالم العربي، ويرى البعض أنها تهدد بإدخال الكثير من الكيانات السياسية العربية، في قائمة الدول الأكثر فشلاً في العالم.
وتتعلق هذه المشكلة بإحدى صور الفساد الخاصة جدًّا، والتي بدأت في التمدد خلال العقدَيْن الأخيرَيْن، وهي هيمنة رجال الأعمال، بنفوذهم ومصالحهم، على الواقع السياسي، وبالتالي المجتمعي في دولهم، وتنفذهم في القرار السياسي، من مستوى العمل الحزبي الأدنى، وحتى مستوى القرار السياسي الإستراتيجي في قصور الحكم.
وأنتجت هذه الحالة، التي طالت أنظمة وحكومات دول راسخة ذات تاريخ عريق، ظاهرة عرفت في الأدبيات السياسية، بظاهرة تزاوج المال والسلطة، وهو أحد أسوأ صور الفساد وفق تعاريف الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية، وتُعتبر بالفعل من أهم بواعث فشل الدولة على المستويَيْن السياسي والمؤسسي.
وفي هذا الإطار، تتناول هذه الورقة مجموعة من الملاحظات على التغيير الوزاري الأخير في الجزائر، ودلالاته في هذه القضية الكبرى، وكيف تقود سياسات الأنظمة الحاكمة إلى هدم الأوطان، وخدمة خصوم الأمة في الخارج.